ما بين حياة اللغة وموتها، تمتد جسور وتشق معابر، وتخاض حروب هويات. وما بين خفوتها وسطوعها، تهدر المطابع بحورا من مداد الحبر، وتثمر المجامع ملايين المصطلحات، فتولد المعاجم وتوضع القواميس لفك شفرات اللغة الحائرة. في حروب اللغات، تجري صراعات وتحمى سباقات همها ضبط "الهويات القاتلة"، ونفي الادعاءات الفاضحة، وكشف الانتماءات الخادعة؛ فكلمة راقصة قد تعلن حربا، ومعنى متأرجحا تضيع بسببه حياة الملايين، وتجري من ورائه أنهار من الدماء.
في نهايات القرن التاسع عشر، التقت لغتان -العربية والفرنسية- على أرض مصر، وكان لقاء الغرباء، ما بين نشوة اللغة الفرنسية المنتصرة وصدمة اللغة العربية المهزومة. كان لا بد من جسر تلتقي فوقه اللغتان، فكانت الترجمة.
لعبت الترجمة في مطلع القرن التاسع عشر دورا محوريا في إرساء دعائم النهضة العربية الحديثة، وكانت ولا تزال همزة الوصل في مشروع إثراء اللغة العربية لغويا ومعرفيا، وأداة فاعلة في تطورها وتحررها من أغلال رسفت في قيودها قرونا طويلة. واللغة العربية هي نفسها التي سادت العالم عدة قرون خلال العصر العباسي، وكانت لغة العلم والمعرفة، وأسهمت في النهضة الأوروبية والثورة الصناعية من خلال ما قامت بنقله من علوم وفلسفة وطب، عبر الترجمة من اللاتينية واليونانية والفارسية.
وحديثا، عبرت اللغة العربية إلى الحداثة على جسر لعبت "الترجمة" فيه دور البطولة، وكان لها باع طويل في تطور اللغة العربية وانتقالها من عصر الركود والاضمحلال إلى عصر النهضة والتقدم. وكثيرا ما راودنا هذا السؤال عن أثر الترجمة في النهوض باللغة العربية وتطورها، ولهذا التقينا ماريانا ماسا، الباحثة في الجامعة الكاثوليكية بميلانو الإيطالية، والمتخصصة في اللغة العربية وآدابها، التي أنجزت دراستها المهمة عن أثر الترجمة من الفرنسية على تطور اللغة العربية المعاصرة في القرن التاسع عشر. فمن خلال دراستها ثلاث عشرة لغة، استطاعت أن تخلص إلى أثر الترجمات على تطور اللغات عموما.
إعلان
درست الدكتورة ماسا تاريخ الترجمة والنصوص المترجمة، وتأثير الترجمة على مراحل حياة اللغة، وكيف أثرت على نشأتها وتطورها، بل وعلى موتها وحياتها. بحثت كيف اختفت اللغة اللاتينية من أوروبا وحلت مكانها لغات أخرى، وكيف تلاشت اللغة القبطية واندثرت بعد أن كانت لغة المصريين قبل الإسلام. كما رصدت أثر الترجمة على ميلاد اللغة وبعثها من جديد بعد أن كادت تموت، كما حدث مع اللغة العبرية الحديثة.
لا خوف على اللغة العربية في مواجهة هجمات اللغات الأخرى. ولماذا لا يكتب العرب ويدرسون مناهجهم باللغة العربية اعتزازا بلغتهم وهويتهم؟
أما عن أثر الترجمة على تطور اللغة العربية، فكان واضحا من خلال المفردات اللغوية في المعاجم، وتطور بناء الجملة العربية. ومع انطلاق النهضة العربية والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع، اكتشفت الباحثة زيادة واضحة في الكلمات والأفعال والصفات المؤنثة، حيث أصبح للمرأة شأن جديد ومختلف عما كان عليه قبل القرن التاسع عشر. ولمست أيضا زيادة ملحوظة في استخدامات الفعل المضارع والمستقبل في مواجهة الفعل الماضي، كما استُحدثت في الكتابات العامة وفي الصحافة كثير من التعبيرات الجديدة التي لم يتطرق إليها الكتاب من قبل.
في حوارها للجزيرة نت، قالت ماريانا ماسا إنه لا خوف على اللغة العربية في مواجهة هجمات اللغات الأخرى، وتساءلت: "لماذا لا يكتب العرب ويدرسون مناهجهم باللغة العربية اعتزازا بلغتهم وهويتهم؟". وطالبت بضرورة تكاتف علماء اللسانيات وخبراء البرمجيات للبحث في بناء قاعدة بيانات رقمية للغة العربية، تستطيع منها الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة. وإلى تفاصيل الحوار:
دراسة أثر الترجمة على تطور اللغة تتطلب معرفة قوية بأكثر من لغة وإجادتها، لماذا اخترت هذا المجال رغم صعوبته؟
أنا محبة للغات عموما، وأتقن ست لغات إتقانا تاما، وملمة بسبع لغات أخرى، ولهذا كان بحثي في تأثير الترجمة على تطور اللغة، الذي أخذني إلى دروب وطرق لم أتصور يوما ما أن أطرقها. درست أثر الترجمة في 13 لغة عالمية، ثم ركزت دراستي على اللغتين العربية والفرنسية في فترة فارقة من تاريخ مصر والمنطقة العربية، مع قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798 وبداية الصحوة العربية الحديثة، حيث كان هناك اتصال كبير بين مصر وفرنسا من خلال البعثات العلمية التي أرسلها محمد علي باشا وأبناؤه إلى فرنسا.
كثيرا من اللغات كانت منطوقة فقط، فكان تأثير الترجمة عليها أن خلقت لها أبجديات لتصبح لغة كتابية تحتل مكانة لغة أخرى ماتت. على سبيل المثال، كانت اللغة اللاتينية منتشرة في كل دول أوروبا، ومع تطور اللهجات الأوروبية، اختفت اللاتينية وأصبحت تلك اللهجات لغات مكتوبة ومنطوقة كما نعرفها اليوم، في حين انقرضت اللغة اللاتينية ولم يعد لها وجود إلا في غرف الأبحاث اللسانية المتخصصة.
كيف تصفين شكل اللغة العربية قبل وبعد هذا التأثر بالترجمة من الفرنسية؟
مع بداية القرن التاسع عشر، كان للترجمة من الفرنسية تأثير كبير على اللغة العربية، ولم يكن هناك سوى إشارات قليلة عن هذا التأثير وآلياته. ماذا حدث؟ وكيف حدث بالضبط؟ لم تكن هناك دراسات متعمقة في هذا التأثير. ورغم صعوبة الموضوع، فإنه كان في غاية المتعة؛ متعة أن ترى اللغة وهي تتطور وتنمو، وكيف كان شكلها قبل الترجمات الحديثة، ثم تطورها بهذا الشكل الذي نراه اليوم خلال رحلة استغرقت قرنين من الزمان تقريبا.
رأيت أن كثيرا من اللغات كانت منطوقة فقط، فكان تأثير الترجمة عليها أن خلقت لها أبجديات لتصبح لغة كتابية تحتل مكانة لغة أخرى ماتت. على سبيل المثال، كانت اللغة اللاتينية منتشرة في كل دول أوروبا، ومع تطور اللهجات الأوروبية، اختفت اللاتينية وأصبحت تلك اللهجات لغات مكتوبة ومنطوقة كما نعرفها اليوم، في حين انقرضت اللغة اللاتينية ولم يعد لها وجود إلا في غرف الأبحاث اللسانية المتخصصة.
إعلان
وفي مصر، من حقنا أن نتساءل عن مصير اللغة القبطية، وهي من اللغات التي انقرضت، مع أنها كانت اللغة المنطوقة في مصر، وكانت لفترة هي لغة الكتابة، بينما كانت اللغة اليونانية هي اللغة المكتوبة والإدارية. وقد استطاع المترجمون نقل اليونانية إلى القبطية، وبعد عدة قرون ومع انتشار الإسلام، تعلم المصريون اللغة العربية لحاجتهم إلى شغل المناصب الإدارية، ثم ترجمت القبطية واليونانية إلى العربية ودخلت في التعاليم الدينية المسيحية، وبقيت اللغة القبطية مقتصرة على بعض السياقات الدينية داخل الكنيسة فقط.
ذكرت أن الترجمة أسهمت في إحياء بعض اللغات، كيف حدث ذلك مع اللغة العبرية مثلا؟
من اللغات التي تم إحياؤها حديثا اللغة العبرية، لغة إسرائيل والأرض المحتلة. فقد انتبه المهاجرون الأوائل من اليهود، عندما نزلوا أرض فلسطين، إلى أنه لا وطن بلا لغة، فدرسوا إحياء اللغة العبرية، وهي لغة كانت مقتصرة على السياق والطقوس الدينية أيضا. وكثيرون لا يعرفون أن اليهود، كي يحيوا لغتهم، درسوا اللغة العربية وتطورها خلال القرن التاسع عشر، وقلدوا نظام اشتقاق الكلمات باللغة العربية لإبداع مفردات جديدة تعبر عن مفاهيم الحياة الحديثة، مثل "قطار" أو "سيارة" أو "طيارة". ولأنها من اللغات السامية مثل العربية، فقد درسوا حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية، وأخذوا نماذج كثيرة منها واشتقوا كلمات جديدة من الجذور العبرية الموجودة، وهكذا نجحوا في إحياء لغتهم القديمة.
كثيرون لا يعرفون أن اليهود، كي يحيوا لغتهم، درسوا اللغة العربية وتطورها خلال القرن التاسع عشر، وقلدوا نظام اشتقاق الكلمات باللغة العربية لإبداع مفردات جديدة تعبر عن مفاهيم الحياة الحديثة، مثل "قطار" أو "سيارة" أو "طيارة". ولأنها من اللغات السامية مثل العربية، فقد درسوا حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية، وأخذوا نماذج كثيرة منها واشتقوا كلمات جديدة من الجذور العبرية الموجودة، وهكذا نجحوا في إحياء لغتهم القديمة.
في نظرك، ومن رحلتك بين حياة اللغات وموتها، كيف ترين مستقبل اللغة العربية، وما الأخطار التي تهددها؟
أقول: لا خوف على اللغة العربية من الاختفاء في مواجهة هجمات اللغات الأخرى؛ فهناك ما لا يقل عن 400 مليون عربي يتحدثونها، وهناك اهتمام متزايد بها بسبب حركات الهجرة العربية المستمرة وشعور الأبناء والأحفاد بالحنين والارتباط بالعروبة. لهذا، تأسست المئات من مراكز تعليم اللغة العربية في المدن الأميركية والأوروبية. وفي الجامعة الكاثوليكية بميلانو، يوجد كثير من الطلاب الإيطاليين من أصول عربية يتطلعون لدراسة اللغة العربية. فلا خوف على اللغة العربية إطلاقا.
لكن عندما ننظر إلى إحصائيات الإنتاج العلمي، فهو قليل جدا في مواجهة هيمنة اللغة الإنجليزية التي تكاد تحتكر لغة العلم الحديثة، حتى الإنتاج العلمي باللغة الإيطالية قليل جدا بالمقارنة. وفي دراسة عن الإنتاج العلمي باللغة العربية سنة 2008، كان أقل من 1% تقريبا.
للنهوض باللغة العربية، أرى أن الحل يكمن داخل كل دولة، عبر النهوض بالإنتاج العلمي، والاعتزاز باللغة الوطنية، والتركيز على الدراسات اللسانية التي تساعد في تطور اللغة. فترة الدراسة التي قمت بها على اللغة العربية كانت مهتمة جدا بالتطور العلمي. ولكي لا نذهب بعيدا، المشكلة الأساسية موجودة في مناهج التعليم باللغة العربية. والسؤال: لماذا لا يكتب العرب ويدرسون مناهجهم باللغة العربية اعتزازا بلغتهم، ويتعلمونها بمنهج جديد؟ وهذا يدعوني للتساؤل: هل المناهج التي يتعلمها التلاميذ في المدارس مناسبة لهم؟ وهل هي مناسبة لهذه الازدواجية اللغوية بين الفصحى واللهجات؟
ما المصادر التي اعتمدت عليها في دراستك لإثبات تأثير الترجمة على اللغة العربية؟
لقد اشتغلت على دراسة تأثير الترجمة على تطور اللغة العربية من خلال المفردات اللغوية في المعاجم منذ زمن محمد علي باشا، وكان هناك تركيز كبير على الكتب المترجمة والمطبوعة في مطبعة بولاق التي أنشأها، ومنها كتب عن صناعة الملابس والطب والطب البيطري والتاريخ والجغرافيا، وكانت كلها كتبا متخصصة. وجدت أن كثيرا من الكلمات في اللغة الفرنسية لم يكن لها مقابل في اللغة العربية، وظهرت دراسات عن كيف تحررت اللغة العربية وانطلقت من عقالها لتسير في ركب الحداثة.
إعلان
ودرست كيف أثرت الترجمة على بناء الجملة العربية، وكيف تغيرت. القواعد العربية (النحو) لم تتغير، ولكن أسلوب الكتابة اختلف. إذا قرأنا نصا للجبرتي وآخر لقاسم أمين، فبالطبع أن الأسلوب اختلف. وتساءلت: لماذا اختلف الأسلوب؟ واستعملت في دراستي للإجابة عن هذا السؤال منهجا علميا اسمه "لسانيات المتون"، حيث جمعت عينات من النصوص، سواء ترجمت عن الفرنسية مباشرة في تلك الفترة، أم كتبها مثقفون عرب سافروا إلى فرنسا وتأثروا باللغة والثقافة الفرنسية، أمثال علي باشا مبارك، وصالح مجدي، وقاسم أمين، وكثير من الشوام الموجودين في مصر أمثال نجيب حداد وأديب إسحاق. وكان للصحافة الفرنسية دور في هذا التطور، فكان المثقفون العرب يقرؤونها، وعليه تأثرت أساليبهم في الكتابة بالأسلوب الصحفي الحديث.
اشتغلت على دراسة تأثير الترجمة على تطور اللغة العربية من خلال المفردات اللغوية في المعاجم منذ زمن محمد علي باشا، وكان هناك تركيز كبير على الكتب المترجمة والمطبوعة في مطبعة بولاق التي أنشأها، ومنها كتب عن صناعة الملابس والطب والطب البيطري والتاريخ والجغرافيا، وكانت كلها كتبا متخصصة. وجدت أن كثيرا من الكلمات في اللغة الفرنسية لم يكن لها مقابل في اللغة العربية، وظهرت دراسات عن كيف تحررت اللغة العربية وانطلقت من عقالها لتسير في ركب الحداثة
هل رصدت تغيرات لغوية محددة مرتبطة بالتحولات الاجتماعية في تلك الفترة؟
نعم، وجدت من تحليل النصوص التي كونتها زيادة وتكرارا في الصيغ المؤنثة؛ من أفعال وصفات وأسماء إشارة وأسماء موصولة. باستخدام منهج "لسانيات المتون" والأدوات التكنولوجية المتاحة، استطعت أن أحدد بدقة إحصائية عدد الأفعال والصيغ المؤنثة في كل مليون كلمة، ووجدت أدلة على زيادة نسبة تكرارها، وأربط هذا التطور في اللغة بظهور الخطاب النسوي في هذه المرحلة. فأحوال النساء لم يكن لها وجود كبير في النصوص العربية حتى جاء أشخاص مثل قاسم أمين ومن قبله رفاعة الطهطاوي. وهنا أطرح سؤالا للباحثين: هل هناك علاقة بين زيادة الألفاظ المؤنثة ونشوء الخطاب النسوي في هذه المرحلة في اللغة العربية؟
ووجدت ضمن بحثي زيادة ملحوظة في استخدامات الفعل المضارع. فمن خلال كتابات المؤرخ المعروف عبد الرحمن الجبرتي، الذي عاصر نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، وجدت أن استخدامات الفعل الماضي أكثر بكثير من نسبة الأفعال المضارعة. ومع ترجمة بعض الأعمال الفرنسية، أصبح هناك توازن وتساو بين الأفعال الماضية والمضارعة، وهذا بتأثير من الترجمة والصحافة، لأن الخطاب المطروح لم يعد يهتم بالماضي فقط، بل بالحاضر وربما بالمستقبل، وهذه موضوعات لم يكن لها وجود من قبل.
وجدت تعبيرات كثيرة كانت مستخدمة في الصحافة والكتابات العامة، جاءت مباشرة من اللغة الفرنسية، مثل عبارات: "بالنظر إلى"، "في الوقت نفسه"، "على الأقل"، "بالأحرى"، "بصفة كذا"، "تحت رعاية…". هذه تعبيرات استخلصتها بمساعدة عالم لغوي كبير هو عبد القادر المغربي، الذي لاحظ ظهورها في الكتابات العربية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وقال إنها تأتي بتأثير مباشر من الترجمات الفرنسية
وهل وجدت تعابير جديدة دخلت اللغة العربية بتأثير مباشر من الترجمة؟
من تحليلاتي اللغوية، وجدت تعبيرات كثيرة كانت مستخدمة في الصحافة والكتابات العامة، جاءت مباشرة من اللغة الفرنسية، مثل عبارات: "بالنظر إلى"، "في الوقت نفسه"، "على الأقل"، "بالأحرى"، "بصفة كذا"، "تحت رعاية…". هذه تعبيرات استخلصتها بمساعدة عالم لغوي كبير هو عبد القادر المغربي، الذي لاحظ ظهورها في الكتابات العربية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وقال إنها تأتي بتأثير مباشر من الترجمات الفرنسية. وما فعلته أنا هو أنني بنيت هذا المتن التاريخي الكبير الذي تتراوح نصوصه من القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين، وبحثت عن هذه العبارات في الفترة الأولى من الدراسة فلم أجدها، أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، صارت هذه العبارات موجودة وبقوة. وأثبت ما قاله الدكتور عبد القادر المغربي من خلال التكنولوجيات الحديثة المعروفة بـ"لسانيات المتون".
كيف تعاملت مع رقمنة اللغة العربية، وما فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمتها؟
لا بد من البحث عن حلول برمجية رقمية لا تأخذ في اعتبارها فقط الكم الهائل من المفردات، ولكن أيضا حركات التشكيل والإعراب. فمن مشاكل البحث التي واجهتني وأنا أستخرج النتائج من النصوص، أن تعريف الكلمة من حيث إعرابها ليس صحيحا دائما؛ فالكلمة تختلف من فعل إلى اسم إلى حرف حسب سياقها اللغوي. وهذا هو الصعب في رقمنة اللغة العربية، حيث الصعوبة كبيرة في قدرة البرامج الحاسوبية على تعريف الحركات العربية، وهذه هي الصعوبة الحقيقية التي نواجهها. لا توجد برامج أو قاعدة بيانات تستطيع ضبط الحركات بحسب سياق الجملة، ولهذا فالأمر يحتاج إلى مزيد من العمل والبحث بين خبراء الحاسوب وعلماء اللغة للتوصل إلى حل للمشكلة.
اللغة العربية متأخرة جدا في عملية الرقمنة، إلا أن هناك جهودا كبيرة في بعض المراكز البحثية، أما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإنها تُفقد العربية بلاغتها في الوقت الحالي
اللغة العربية متأخرة جدا في عملية الرقمنة، إلا أن هناك جهودا كبيرة في بعض المراكز البحثية. ففي جامعة أبوظبي، يوجد أحدث نظام تعريفي حاسوبي للحركات العربية في "لسانيات المتون" اسمه (CAMEL) "جمل"، وقد اعتمدت على هذا المنهج. وهناك جهود أخرى كثيرة، مثل إتاحة المعجم التاريخي للغة العربية بالشارقة، الذي يعد إضافة كبيرة في دراسة تاريخ الكلمات، وقد اعتمدت عليه في دراسة تاريخ كلمات مثل "أمة"، "جمهور"، "كهرباء"، و"قنبلة"؛ حيث يحكي المعجم تاريخ الكلمة منذ أن استخدمت أول مرة، وكيف تطورت وتغيرت معانيها، وهذا دليل مهم جدا لكل من يدرس تاريخ اللغة.
إعلان
أما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإنها تُفقد العربية بلاغتها في الوقت الحالي. أبحاث الذكاء الاصطناعي تتضمن جانبا كبيرا من التطبيقات على اللغة العربية وترجمتها، ولكن هذه النماذج اللغوية الكبرى دُربت، (مثل Gemini, ChatGPT, Claude AI)، باللغة الإنجليزية، فهي نماذج ذات تركيب يشبه اللغة الإنجليزية. الجملة العربية أحيانا تشبه الإنجليزية وأحيانا تختلف عنها، وعموما أرى أن اللغة العربية الناتجة عن هذه النماذج فاقدة لكثير من بلاغتها وفصاحتها. لكي نرتقي باللغة العربية عن طريق هذه الآليات الجديدة، لا بد من تدريب هذه النماذج بنصوص عربية بليغة فصيحة، وليس باللغة الإنجليزية. وكيف يتم ذلك؟ بالجمع بين المهارات اللغوية والحاسوبية، والتعاون بين خبراء اللسانيات وخبراء الحاسوب لإيجاد نموذج تدريب عربي كبير، حتى نجد نصوصا عربية تعطينا إجابات فصيحة لا نشعر أنها كتبت باللغة الإنجليزية.
تموت اللغة عندما يهجرها أهلها والمتحدثون بها، وتموت عندما تستبدل بلغات أخرى، كما في حالة اللغة اللاتينية التي استبدلت باللغات الأوروبية. وكان للنصوص الدينية سبب في اختفاء اللاتينية، لأنه كان هناك احتياج لتوصيل هذا المحتوى الديني للشعب الأمي الذي لا يفهم اللاتينية. وفي ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، تم إبداع لغات جديدة. وهذا التغيير استغرق قرونا ولم يحدث فجأة
أخيرا، عن حياة اللغة وموتها، متى يمكن أن نقول بموت لغة ما، وما شروط إحيائها؟
تموت اللغة عندما يهجرها أهلها والمتحدثون بها، وتموت عندما تستبدل بلغات أخرى، كما في حالة اللغة اللاتينية التي استبدلت باللغات الأوروبية. وكان للنصوص الدينية سبب في اختفاء اللاتينية، لأنه كان هناك احتياج لتوصيل هذا المحتوى الديني للشعب الأمي الذي لا يفهم اللاتينية. وفي ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، تم إبداع لغات جديدة. وهذا التغيير استغرق قرونا ولم يحدث فجأة. اتهم مارتن لوثر بالهرطقة من الكنيسة لأنه ترجم الإنجيل من اللاتينية إلى الألمانية المنطوقة. وفي إيطاليا في القرن الخامس عشر، كتب دانتي دراسة عن "بلاغة العامية"، حيث تناول الكتابة الأدبية بالعامية، وطرح تفوق اللغات الطبيعية الحية على اللاتينية، وهذا يعد تصرفا ثوريا في عصره.
وهكذا، تموت اللغات بانصراف الناطقين بها عنها أو استبدالها بلغات أخرى. هذا ما حدث مع اللغة القبطية التي استبدلت بالعربية، وحدث مع اللغة التركية الحديثة ولكن قسريا عندما قرر كمال أتاتورك استبدال الأبجدية العربية باللاتينية، واستبدال كلمات من أصول عربية بأخرى من أصول تركية. كان هذا قرارا سياسيا، ورأى أتاتورك، وهو عالم لغة، في ذلك استقلالا للأمة التركية بهوية بحتة، وطبق المناهج الدراسية باللغة التركية الجديدة. وهذا ما تم أيضا لإحياء اللغة العبرية في الأرض المحتلة، حيث تم تعميم المناهج الدراسية بالكامل باللغة العبرية الجديدة.
هناك علاقة طردية بين تطور اللغة وزيادة عدد المتحدثين بها؛ فكلما زاد الإنتاج العلمي للغة ما، زاد عدد مستخدميها وتطورها. والعكس صحيح؛ فإذا هجر المتكلمون لغتهم، ماتت وذوت واندثرت.





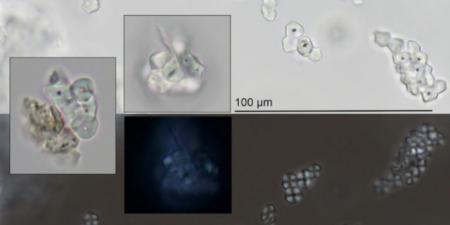

0 تعليق